
تتناول هذه الدراسة التي أعدها مركز أودغست للدراسات الاقليمية، تصاعد النفوذ الروسي في منطقة الساحل الإفريقي باعتباره أحد أبرز ملامح التغيير في معادلة التوازنات الدولية داخل الإقليم. فقد تمكنت موسكو، عبر أدوات غير تقليدية أبرزها مجموعة "فاغنر"، من ملء الفراغ الذي خلفه تراجع النفوذ الفرنسي، وبنت شراكات استراتيجية جديدة مع أنظمة انتقالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بينما تسعى إلى اختراق دول أخرى.
وتحذر الدراسة من أن هذا الحضور الروسي، رغم ما يمنحه لبعض الأنظمة من هوامش سيادية وأدوات ضغط على الغرب، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تشمل تآكل الهياكل الأمنية التقليدية، وتزايد هشاشة الدولة، وتصاعد الاستقطاب بين القوى الكبرى.
أما موريتانيا، فتمثل حالة خاصة في هذا المشهد: دولة مستقرة نسبيا، لكنها مجاورة مباشرة لمناطق النفوذ الروسي، مما يجعلها أمام معادلة حساسة. فإما أن تستثمر موقعها الجغرافي والدبلوماسي لتطرح نفسها كفاعل توازني وشريك موثوق للغرب، أو أن تجد نفسها عرضة لضغوط متقاطعة إذا تصاعد التنافس الدولي في المنطقة.
انطلاقا من ذلك، توصي الدراسة بضرورة صياغة سياسة خارجية مرنة، وتعزيز القدرات الدفاعية والاستخباراتية، وتوسيع قاعدة الشراكات التنموية، مع دعم التحليل الاستراتيجي الوطني لرصد التحولات وإسناد القرار السيادي.
مقدمة
تشهد منطقة الساحل الإفريقي منذ مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين تحولا استراتيجيا لافتا في خارطة النفوذ الدولي، نتيجة تزايد التهديدات الأمنية، وتراجع الدور الفرنسي، وصعود فواعل جديدة ذات منطلقات مغايرة للنفوذ الغربي التقليدي. في هذا السياق، تبرز روسيا كفاعل دولي يعيد بناء موقعه في المنطقة استنادا إلى منطق القوة غير المتناظرة، عبر أدوات غير تقليدية تتجاوز البعثات الدبلوماسية أو التعاون الحكومي الرسمي، لتشمل توظيف شركات أمنية خاصة، وبناء تحالفات مع أنظمة انتقالية، وتفعيل خطاب سيادي مناهض للغرب.
لقد شكل الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية من مالي في عام 2022، ثم من بوركينا فاسو والنيجر لاحقًا، فرصة استراتيجية للنفوذ الروسي الذي سرعان ما وجد موطئ قدم عبر مجموعات مثل "فاغنر"، التي تحولت من مجرد قوة شبه عسكرية إلى أداة جيوسياسية بامتياز. وترافق هذا التحول في التموضع الروسي في الساحل مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، مما جعل إفريقيا – وخاصة الساحل – إحدى جبهات الصراع غير المباشر بين روسيا والغرب.
وتطرح هذه الدينامية أسئلة محورية حول طبيعة الأهداف الروسية، وحدود قدرتها على التأثير، والنتائج المترتبة على تمددها في بيئة شديدة الهشاشة الأمنية والدولية. كما أن هذا الحضور يفرض تحديات بالغة على دول المنطقة، ومنها موريتانيا، التي تجد نفسها مضطرة إلى الموازنة الدقيقة بين انفتاحها المتزايد على الشراكة مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من جهة، والحذر من التوتر مع روسيا من جهة أخرى.
تنطلق هذه الورقة من فرضية أن روسيا، بما تمتلكه من إرث استراتيجي وطموحات جيوسياسية معاصرة، تسعى إلى إعادة تشكيل حضورها في إفريقيا عبر منطقة الساحل، مستفيدة من فراغ النفوذ الغربي والأزمات البنيوية في الدول الإفريقية. وتفترض الدراسة أن هذا الحضور الروسي ليس مجرد رد فعل تكتيكي، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لإعادة التموقع في الجنوب العالمي، وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية في المدى المتوسط.
وتحاول الورقة – من خلال تتبع أدوات روسيا في الساحل، وتحليل خرائط حضورها، واستشراف سيناريوهات المستقبل – أن تقدم قراءة شاملة لطبيعة هذا النفوذ وآثاره على موازين القوى في الإقليم، وعلى تموقع دول مثل موريتانيا التي تواجه خيارات دقيقة في زمن التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
أولا: السياق الاستراتيجي لتحركات روسيا في منطقة الساحل
لم تكن عودة روسيا إلى القارة الإفريقية، ولا إلى منطقة الساحل تحديدا، خطوة ارتجالية أو استجابة ظرفية فقط، بل جاءت في إطار سياسة خارجية روسية جديدة تبناها الكرملين منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، تعيد فيها موسكو رسم علاقتها مع العالم غير الغربي باعتباره ساحة حيوية لكسر الأحادية القطبية وتوسيع مجال نفوذها الاستراتيجي. وقد تأكد هذا التوجه بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وما أعقبه من عزلة غربية دفعت روسيا إلى تكثيف حضورها في مناطق ذات رمزية جيوسياسية، ومنها الساحل الإفريقي.
تأتي أهمية منطقة الساحل بالنسبة لروسيا من عدة اعتبارات متداخلة. فمن جهة، تمثل المنطقة خاصرة رخوة للنفوذ الغربي، وخصوصا الفرنسي، الذي ظل يهيمن لعقود على السياسة والاقتصاد والأمن في دول الساحل، ما جعلها ساحة مثالية لتقويض هذا النفوذ عبر وسائل أقل تكلفة وأعلى رمزية. ومن جهة ثانية، توفر منطقة الساحل بوابة محتملة للوصول إلى المحيط الأطلسي وامتداده الاستراتيجي، في إطار سعي روسيا إلى إعادة التمركز البحري عالميا. ومن جهة ثالثة، يُعد الساحل منصة مثالية لتوسيع العلاقات مع أنظمة انتقالية تبحث عن بدائل للدعم الغربي المشروط، وهو ما يتناسب مع المقاربة الروسية التي تركز على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما تتقاطع هذه الاعتبارات مع الرغبة الروسية في إعادة الاعتبار لدورها كقوة عظمى، عبر تحقيق اختراقات في مناطق النفوذ التقليدية للغرب، وتقديم نموذج دعم أمني وسياسي لا يرتبط بالشروط الديمقراطية أو الحقوقية التي تطرحها الدول الغربية. لذلك، فإن تحركات روسيا في الساحل تأتي كجزء من منطق استراتيجي أوسع، يعيد تعريف التحالفات، ويختبر حدود القوة والنفوذ في عالم يتجه نحو تعددية قطبية غير مستقرة.
ثانيا: أدوات النفوذ الروسي في منطقة الساحل
لعل ما يميز التمدد الروسي في منطقة الساحل الإفريقي ليس فقط توقيته أو سرعته، بل طبيعة الأدوات المستخدمة فيه، والتي تختلف عن الأنماط الغربية التقليدية في بسط النفوذ. فمنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تبنت روسيا مقاربة هجينة تمزج بين الحضور الرسمي للدولة (عبر وزارتي الخارجية والدفاع) وبين توظيف فاعلين غير حكوميين، من أبرزهم مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية. كما استخدمت موسكو أدوات اقتصادية وإعلامية ونفسية لتوسيع حضورها وتعزيز صورتها كشريك بديل للغرب.
في مقدمة هذه الأدوات، تأتي الشركات الأمنية الخاصة، وعلى رأسها "فاغنر"، التي مثّلت رأس الحربة في التمدد الروسي داخل مالي وبوركينا فاسو، حيث لا تكتفي فاغنر بتوفير خدمات الحماية والتدريب العسكري والقتال أحيانا إلى جانب القوات الحليفة، بل غالبا ما ترتبط باتفاقيات لتأمين منشآت استراتيجية، ومرافقة النخب الحاكمة في ظروف انتقالية، مقابل امتيازات اقتصادية تتراوح بين عقود التعدين والسيطرة على بعض البنى التحتية.
كما تشكل الدبلوماسية السيادية أداة رئيسية في الخطاب الروسي، حيث تحرص موسكو على تقديم نفسها كحليف لا يشترط الإصلاحات السياسية أو الالتزام بالمعايير الغربية، ما يجعلها شريكا مفضلا للأنظمة التي تنظر بريبة إلى مشروطية التعاون الغربي. وتقوم هذه الدبلوماسية على تنظيم قمم دورية مع الدول الإفريقية، وتوقيع اتفاقيات تعاون دفاعي، وإبراز رمزية الدعم الروسي في المحافل الدولية.
أما النفوذ الإعلامي والدعائي، فيبرز من خلال بث خطاب مناهض للغرب عبر وسائل إعلام روسية ناطقة بالفرنسية، والترويج لروايات بديلة حول فشل فرنسا في حفظ الأمن، وإبراز روسيا كقوة عادلة تدعم السيادة الوطنية. ويستخدم هذا الخطاب لتغذية المزاج الشعبي في بعض دول الساحل، وتعزيز مشروعية الأنظمة المتقربة من موسكو.
كما تلجأ روسيا إلى أدوات التأثير الاقتصادي غير المباشر، من خلال استثمارات في مجالات الطاقة والتعدين، أو عبر مقايضات عسكرية-اقتصادية، كمنح التسهيلات اللوجستية أو العقود التفضيلية في مقابل الدعم العسكري أو الاستخباراتي. ورغم أن حجم هذه الاستثمارات لا يزال محدودا مقارنة بالصين أو الغرب، إلا أن دلالاتها السياسية تتجاوز قيمتها المادية.
ثالثا: خرائط التأثير الروسي في دول الساحل
يمتد النفوذ الروسي في منطقة الساحل الإفريقي بشكل متفاوت من دولة إلى أخرى، باختلاف السياقات السياسية والأمنية المحلية، وكذلك حسب استعداد النخب الحاكمة للتفاعل مع المبادرات الروسية. ويبرز هذا الحضور بشكل واضح في دول مثل مالي وبوركينا فاسو، حيث استطاعت روسيا، عبر أدواتها غير التقليدية، أن تحل محل النفوذ الفرنسي المتراجع، وأن تبني شراكات أمنية سريعة مع السلطات الانتقالية، في مقابل دعم سياسي وميداني مباشر.
في مالي، تعد تجربة التموقع الروسي الأكثر اكتمالا حتى الآن. فبعد انسحاب القوات الفرنسية في 2022، سارعت باماكو إلى توقيع اتفاقيات أمنية مع موسكو، وأعلنت انفتاحها على التعاون مع فاغنر، التي بدأت مهامها في تدريب القوات المحلية، وتأمين المنشآت الحكومية، ومرافقة عمليات مكافحة الإرهاب، مع اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات حقوقية. هذا الانخراط سمح لروسيا بالحصول على عقود في قطاع التعدين، وتعزيز حضورها الرمزي في الخطاب السياسي المحلي، خاصة في ظل تصاعد النقمة الشعبية على الإرث الاستعماري الفرنسي.
أما في بوركينا فاسو، فقد استغلت موسكو الانقلاب العسكري في 2022 وما أعقبه من فتور في العلاقات مع باريس وواشنطن، لتعزيز حضورها تدريجيا، عبر الوفود السياسية والعسكرية، وخطاب سيادي يجد صدى واسعا في النخبة الجديدة. وعلى الرغم من أن حجم الدعم الروسي لا يزال محدودا مقارنة بالحالة المالية، فإن بوادر التمركز الاستراتيجي الروسي بدأت تظهر، خاصة من خلال التنسيق الإعلامي والسياسي مع باماكو، لتقديم نموذج إقليمي موحد في مواجهة ما يوصف بـ"التدخل الغربي"، أو التعاون ضمن إطار كونفدرالية دول الساحل.
أما النيجر، فعرفت تحولا حاسما بعد انقلاب 2023، إذ علقت الشراكة مع فرنسا والولايات المتحدة، وبدأت في الانفتاح الحذر على العروض الروسية، وسط تباين داخل النخب العسكرية بشأن جدوى هذا التوجه. ومع أن موسكو لم تحقق بعد اختراقا واضحا في نيامي، فإن البيئة السياسية هناك مرشحة لاحتضان النفوذ الروسي، خاصة إذا استمرت العزلة الغربية وتصاعدت المطالب بسياسات أمنية بديلة.
في المقابل، تعد موريتانيا حالة خاصة في هذا السياق؛ فهي لم تشهد أي تقارب رسمي مباشر مع روسيا، ولا وجود لفاغنر أو أدوات التأثير الروسية التقليدية داخل أراضيها. غير أن موقعها الجيوسياسي المحاذي لمناطق النفوذ الروسي، واستقرارها النسبي، يجعل منها نقطة مراقبة حذرة لهذه التحولات. فموريتانيا تدرك أن أي تمدد روسي في دول الجوار يمكن أن يفضي إلى تداعيات أمنية إقليمية تمس حدودها، وأن حيادها النسبي قد لا يصمد طويلا إذا ما اندفع الإقليم نحو مزيد من الاستقطاب بين موسكو والغرب.
رابعا: التهديدات والفرص الناتجة عن النفوذ الروسي في الساحل
لا يمكن فهم التمدد الروسي في منطقة الساحل بمعزل عن آثاره المتعددة على المستويين المحلي والدولي، إذ يحمل هذا الحضور في طياته تهديدات وفرصا في آن واحد. فهو يعيد تشكيل التوازنات التقليدية، ويعمق الاستقطاب بين القوى الكبرى، ويخلق تحولات في أولويات الشركاء الدوليين. وتختلف تداعيات هذا الحضور باختلاف زاوية النظر: فبالنسبة للغرب، يعد تمدد روسيا تهديدا مباشرا لمصالحه الأمنية والاقتصادية، بينما تنظر إليه بعض الأنظمة المحلية كفرصة لإعادة التفاوض على علاقاتها مع الشركاء التقليديين.
من أبرز التهديدات التي يثيرها النفوذ الروسي، تآكل الدور الغربي في المنطقة، وخاصة الفرنسي، الأمر الذي أحدث فراغا في منظومة الأمن الإقليمي لم يملأ بعد بحلول مستقرة أو توافقية. وقد ساهم هذا التراجع في تعزيز حالة عدم اليقين، وتصاعد الاعتماد على الفواعل غير الحكومية، مما أدى إلى انفلات أمني في بعض المناطق الحدودية بين دول الساحل. كما تتهم المجموعات المرتبطة بروسيا، مثل فاغنر، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، ما يهدد بنسف قواعد حقوق الإنسان، ويقوض شرعية الأنظمة المتحالفة معها على المدى الطويل.
في المقابل، يوفر الحضور الروسي لبعض الدول الإفريقية فرصة للهروب من المشروطية الغربية، واستغلال التنافس الدولي للحصول على عروض أمنية أكثر مرونة، أو لتحقيق استقلال نسبي في قراراتها السيادية. وقد تمكنت بعض الأنظمة الانتقالية، مثل حكومة مالي، من استخدام العلاقة مع موسكو كأداة للضغط على الشركاء الغربيين، ما أدى إلى إعادة تشكيل الخطاب الوطني حول مفاهيم السيادة ومناهضة التدخل الخارجي.
أما بالنسبة لموريتانيا، فإن هذا الواقع يفرض تحديات دقيقة، فمن جهة، يفتح التمدد الروسي الباب أمام تهديدات أمنية غير مباشرة، خصوصا في حال تحولت المناطق القريبة من حدودها إلى ساحات نفوذ روسي خارج الإطار الرسمي، مما قد يؤدي إلى تنامي نشاط الجماعات المسلحة، أو اختلال التوازنات الحدودية. ومن جهة أخرى، يمكن لموريتانيا أن تستثمر هذه التحولات لإعادة التموقع الاستراتيجي، من خلال تأكيد شراكتها مع الغرب، وطرح نفسها كدولة توازن قادرة على تعظيم عائداتها من الواقع الاقليمي الجديد..
تبرز هذه المعطيات مجتمعة هشاشة المعادلة الأمنية والسياسية في الساحل، وتعقد مسارات بناء شراكات مستقرة في ظل التنافس الدولي. كما تظهر أن النفوذ الروسي، وإن كان يمثل تحديا، إلا أنه يكشف أيضا عن اختلالات كامنة في النظام الإقليمي القائم، ويطرح فرصا لإعادة التفكير في آليات التعاون الدولي ومفهوم السيادة في إفريقيا.
وعليه، فإن التعامل مع النفوذ الروسي يتطلب قراءة مزدوجة: قراءة أمنية حذرة تراعي المخاطر المرتبطة به، وقراءة استراتيجية تستثمر في تعددية الخيارات دون الارتهان لمحور بعينه، وهو ما يتطلب من دول مثل موريتانيا هندسة دبلوماسية دقيقة تراعي موازين القوى وتخدم مصالحها الوطنية.
خامسا: سيناريوهات مستقبلية للنفوذ الروسي في الساحل
تبعا للتطورات الراهنة، وتعدد العوامل المؤثرة في حضور روسيا بمنطقة الساحل الإفريقي، يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسية تحدد المسارات الممكنة لهذا النفوذ خلال السنوات القادمة، مع ما يحمله كل منها من انعكاسات أمنية وجيوسياسية على الإقليم، وعلى دول مثل موريتانيا.
السيناريو الأول: التصعيد التدريجي للنفوذ الروسي
في هذا السيناريو، تستفيد موسكو من انسحاب الشركاء الغربيين، ومن دعم شعبي محلي متزايد في بعض دول الساحل، لتعزيز حضورها العسكري والسياسي والاقتصادي. ويتمثل هذا السيناريو في تكريس التحالفات القائمة، وتوسيع الانتشار الجغرافي لفاغنر أو بدائلها، والدفع نحو علاقات أوثق مع أنظمة انتقالية راغبة في التخلص من الاعتماد على الغرب. وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد تصبح روسيا لاعبا مهيمنا على التوازنات الأمنية في الساحل، ما يفاقم الاستقطاب الدولي، ويعقد من موقع دول محايدة مثل موريتانيا.
السيناريو الثاني: احتواء النفوذ الروسي عبر شراكات أطلسية–إفريقية
يفترض هذا السيناريو نجاح الدول الغربية، خصوصا عبر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، في بناء تحالفات بديلة مع الفاعلين الإقليميين، وإعادة صياغة استراتيجيات التدخل في الساحل على نحو أكثر احتراما للخصوصيات المحلية.
كما يراهن على تحركات ديبلوماسية واقتصادية أكثر نجاعة لقطع الطريق على التمدد الروسي. وإذا تحقق هذا السيناريو، قد تستفيد موريتانيا من تعزيز موقعها كشريك موثوق، بشرط أن تتفادى التورط المباشر في التنافس بين الكتل الكبرى.
السيناريو الثالث: التوازن الدينامي بين القوى الكبرى
يرتكز هذا التصور على نشوء وضعية "تعايش تنافسي" بين روسيا من جهة، والغرب والصين من جهة أخرى، حيث يتم تقاسم النفوذ بشكل غير رسمي في الساحل، مع احترام نسبي للمجالات الحيوية لكل طرف. ويمثل هذا السيناريو مخرجا واقعيا لتجنب الصدام المفتوح، ويتيح للدول الإفريقية بعض هامش المناورة في علاقاتها الخارجية. وبالنسبة لموريتانيا، قد يوفر لها هذا الوضع فرصة لتعزيز دورها كوسيط أو شريك متوازن، شريطة أن تمتلك سياسة خارجية واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التعدد في العلاقات.
السيناريو الرابع: الانفجار الإقليمي وفوضى النفوذ
في هذا السيناريو السلبي، تؤدي التناقضات بين الفاعلين الدوليين، وفشل النخب المحلية في إدارة التحولات، إلى تصاعد الفوضى الأمنية، وتحول بعض دول الساحل إلى ساحات نفوذ متصارع دون ضوابط واضحة. يتزامن ذلك مع تنامي دور الجماعات المتطرفة، وانهيار شبكات التعاون الإقليمي. وفي حال تحقق هذا السيناريو، ستكون موريتانيا أمام تحديات حادة، تستلزم بناء دفاعات وطنية صلبة، وتبني مقاربة أمنية إقليمية شاملة، وتجنب الانجذاب إلى محاور متصارعة.
تظهر هذه السيناريوهات أن مستقبل النفوذ الروسي في الساحل لا يتوقف فقط على إرادة موسكو أو مواقف الدول الغربية، بل يتشكل أيضا بفعل العوامل المحلية، وقدرة الدول الإفريقية على امتلاك زمام المبادرة، وتوجيه علاقاتها الدولية بما يخدم استقرارها وأمنها الوطني. وفي هذا السياق، تبدو موريتانيا أمام لحظة استراتيجية تستدعي حسن التقدير، والتصرف كفاعل مستقل في بيئة تتجه نحو المزيد من التعقيد والتعدد في مراكز القرار الدولي.
الخاتمة والتوصيات:
يتضح من خلال هذه الورقة أن الحضور الروسي في منطقة الساحل الإفريقي لم يعد مجرد ظاهرة عابرة أو رد فعل على انسحاب قوى تقليدية، بل تحول إلى مشروع استراتيجي متكامل يوظف أدوات مركبة تتراوح بين الأمن والدبلوماسية والدعاية الاقتصادية. وقد مكن تراجع النفوذ الفرنسي، وصعود أنظمة سياسية انتقالية تبحث عن شراكات جديدة، من تهيئة بيئة مواتية للتمدد الروسي، الذي وجد في حالة الفراغ وانعدام الثقة فرصة لإعادة التموقع في واحدة من أكثر المناطق حساسية على المستوى الإفريقي.
كما أن أدوات هذا الحضور الروسي، بدءا من فاغنر وصولا إلى آليات التأثير الإعلامي والدبلوماسي، قد ساهمت في إعادة صياغة معادلات القوة في الفضاء الساحلي، حيث أصبحت موسكو فاعلا لا يمكن تجاهله في التفاعلات الأمنية والسياسية، سواء من طرف القوى الغربية أو من قبل دول المنطقة نفسها. وتكمن خطورة هذا التموقع في ارتباطه أحيانا بأنظمة غير مستقرة، ما يجعل تأثيره عرضة للتذبذب، ويغذي حالات من الانقسام الداخلي أو التوتر الإقليمي.
وفيما يتعلق بموريتانيا، فإن وضعها الجغرافي كدولة حدودية مع مناطق النفوذ الروسي المباشر (مالي تحديدا)، واستقرارها السياسي النسبي، يمنحانها هامشا مهما من المناورة، لكنه هامش محفوف بالمخاطر إذا لم تبن سياساتها الخارجية على أساس رؤية استراتيجية واضحة. إن التحولات الراهنة تضع نواكشوط أمام تحدي الحفاظ على الاستقلالية في القرار، مع ضمان عدم تحوّلها إلى ساحة صراع غير مباشر بين موسكو والغرب، أو إلى منطقة عازلة تخضع لضغوط متضاربة.
بناء على ما سبق، توصي الدراسة بما يلي:
1. صياغة سياسة خارجية مرنة متعددة المحاور، توازن بين الانفتاح على الشركاء الغربيين والانتباه لخطوط الاتصال مع موسكو، دون انخراط مفرط في أي محور.
2. تعزيز البنية الدفاعية والاستخباراتية الوطنية، بما يمكن موريتانيا من مواجهة أي ارتدادات محتملة للنفوذ الروسي في دول الجوار، خاصة من حيث نشاط الجماعات المسلحة.
3. تنشيط الدبلوماسية الإقليمية، من خلال تقوية التعاون مع الدول الساحلية المستقرة، وإنشاء آليات مشتركة للتعامل مع النفوذ الأجنبي على أسس تكاملية، لا تنافسية.
4. إعادة تعريف الشراكات الأمنية مع الغرب، بما يضمن إدماج الجانب التنموي والتقني، وعدم اختزال العلاقة في البعد الأمني فقط، لتفادي خلق تبعيات يصعب تسييرها على المدى البعيد.
5. دعم البحث والتحليل الاستراتيجي الوطني، عبر مراكز دراسات مستقلة ومؤسسات أمنية قادرة على رصد التحولات الدولية وتحليل تداعياتها محليا، ما يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على معرفة معمقة وسيناريوهات واقعية.
في المحصلة، فإن مستقبل موريتانيا في ظل صعود روسيا في الساحل لن يحسم بمواقف آنية أو ردود فعل ظرفية، بل يتطلب تموقعا عقلانيا يستشرف الاتجاهات، ويوازن بين السيادة والانخراط، ويعتمد على أدوات وطنية قادرة على استيعاب تعقيدات التحولات الجيوسياسية في محيط متغير




.jpeg)


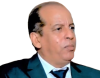










.jpeg)